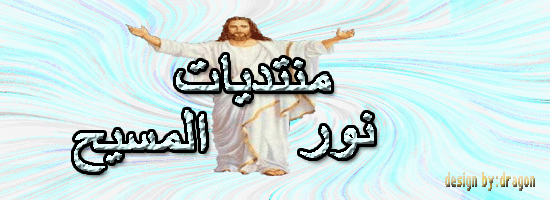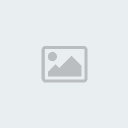بقلم الدكتور صموئيل عبد الشهيد
من أبرز العقائد المسيحية في الكتاب المقدس
عقيدة "الله محبة". ولا شك أنَّ الله محبة لأن
المحبة الإلهية هي في صُلب العلاقة الإلهية -
البشرية. فلولا محبة الله للإنسان لقُضي على
الإنسان منذ لحظة السقوط الأولى، ولكان درب
الخلاص قد أُغلق في وجه الإنسان إلى الأبد.
ولكن الله الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله،
لم يترك الإنسان ضحية تمرده، وغبائه، وميوله
الشريرة، بل سارع لكي ينقذه من الحالة الرهيبة
التي أصبح عليها، لأن الله محبة.

هذه حقيقة لا
يجوز لهذا الكائن البشري المدعو إنساناً أن
يتجاهلها لأنها هي الرابطة التي حفّزت
رب العالمين أن يخطّط لبناء جسر الخلاص حتى
منذ قبل تأسيس
العالم. وعندما أخذ الرب الإله يتعامل مع
الإنسان كشف له، وبصورة تدريجية،
إما عن طريق الوحي، أو الكلمة المكتوبة،
أو الأنبياء، عن المخطط الإلهي الذي
ادّخره لإنقاذ الإنسان
من عبودية الخطيئة، ومن المصير المحتوم الذي
جرَّ إليه نفسه.
فهذه العلاقة هي علاقة تاريخية وإن اتخذت في
أزمان مختلفة أشكالاً رمزية كالكفّارات،
والذبائح، أو صوراً روحية تتعلق بنقاء القلب،
والطاعة لشريعة الله، وممارسة الفضائل،
والإيمان بإله واحد. ولكن هذه المحبة، بل هذه
العلاقة ظلت، إلى حد ما، مكفَّنة
بالضباب
نراها كالأشباح أحياناً، أو تبدو أكثر تجلياً
أحياناً أخرى إلى أن جاء ملء الزمان، الرب
يسوع المسيح، تحقيقاً لجميع هذه الرموز،
والنبوات التي اكتظ بها العهد القديم. إن تجسد
المسيح؛
آخذاً
صورة عبد، صائراً في شبه الناس، كان أبلغ
تعبير عن هذه المحبة الإلهية؛ وعندما أسلم
نفسه، وعُلِّق على خشبة الصليب،
أخذت تلك المحبة أبعاداً جديدة:
أولاً: لأنها كانت تتويجاً للعلاقة التاريخية
بين الإنسان والله.
وثانياً: لأن موت المسيح على الصليب وفداءه
للجنس البشري المحكوم عليه بالهلاك الأبدي كان
أسمى تعبير عن عظم محبة الله.. لأن المسيح لم
يمت من أجل خلاص الأبرار بل مات من أجل فداء
الأشرار؛
وثالثاً: لأن هذه المحبة هي شاملة متوافرة لكل
من يسعى وراءها ليتمتع بمراحم الله وغفرانه
وفدائه.
هذه هي الصورة العامة لمحبة الله للإنسان.
ولكن لسوء الحظ، فإن فئات متعددة من
المتفقِّهين أخذوا يؤوِّلون "محبة الله"
تأويلات شاذة شوَّهت معناها، وبدّلت من
أهدافها، وتلفعت بخداع النفس إذ جعلت "محبة
الله" ألعوبة في أيديهم ففسروها وفق أهوائهم،
لتتفق مع ميولهم، ومعتقداتهم، وأساليب حياتهم،
بل ونظرتهم إلى الأبدية.
ولدينا في المجتمع المعاصر أمثلة كثيرة على
ذلك. فهناك إحدى الطوائف التي تدعو ذاتها
مسيحية، ولكنها تعلّم أعضاءها أن الله، لأنه
محبة، لن يعاقب الإنسان على خطيئته بل إن
رحمته تغفر له آثامه، فليس هناك دينونة وليس
هناك عذاب أبدي، وبعضهم يدَّعون قائلين: حتى
لو كان هناك عقاب ودينونة وجحيم، فإن هذه
حالات مؤقتة، وسيأتي ذلك اليوم الذي فيه يُفني
الله جهنّم، وجميع الناس، بلا استثناء يخلصون،
ويتمتعون ببركات السماء.
وهناك أيضاً من جعلوا مبدأ المحبة مبدأ
مبتذلاً، واتخذوا منه أعذاراً لإشباع شذوذهم
الجنسي، وحوّلوا معنى العائلة، والعلاقة بين
الزوج والزوجة، وصاغوهما صياغة جديدة، واضعين
فيهما اللوم - إن كان هناك لوم - على الله
لأنه هو الذي خلقهم على تلك الصورة وجعلهم
منحرفين. بل إنهم تفادوا استخدامات مفردات
الشذوذ والانحراف، واختاروا ألفاظاً أخرى،
كالميول، والاتجاهات، والنوازع، وكل ذلك
تهرّباً من الواقع المرعب. وكأنما تناسوا أن
هذه كانت خطيئة سدوم وعمورة التي أدّت إلى
دمار هاتين المدينتين. ومع ذلك، فإن أصحاب هذه
الاتجاهات يتمسكون بـ "محبة الله"، ويرون فيها
مهرباً لذنوبهم وآثامهم، وقد استكانوا إلى هذه
الفكرة وارتاحت نفوسهم إليها، وهكذا تخدَّرت
إرادتهم، وتكبّلت عقولهم، وطرحوا كل ما جاء في
كتاب الله المقدس من نصوص واضحة، إن كان في
العهد القديم، أو في العهد الجديد، مدّعين
أنها كانت تعبّر عن حضارة ذلك الزمان، وأننا
نعيش في عصر مختلف له مفاهيمه الخاصة به،
وأصوله التي تبيح ما كان محرّماً، وترضى بما
كان مُنكراً. كل هذا باسم "محبة الله". ومن
المؤسف حقاً أن نرى بعض رجال الدين، يقفون
وراء هذه الاتجاهات، وأن بعض طوائفهم تؤيدهم
في باطلهم، بل إن هناك كنائس قد تأسست لتضم في
عضويتها أصحاب الشذوذ من رجال ونساء تحت رعاية
قسوس ينتمون إلى ذات الاتجاه.
ولكن هؤلاء جميعاً تغافلوا عن بعض الحقائق
العامة التي لا بدّ من معالجتها في هذه
المقالة القصيرة.